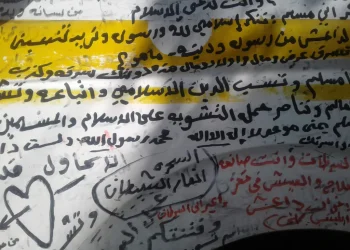بعد ثماني سنوات من رحيل قسري فرضته تعقيدات الحرب، قرار العودة إلى تعز، لا يمكن اتخاذه بتسرع ناجم عن حنين جارف لمدينة شهدت طفولتك الأولى، وصداقاتك المبكرة، وطيش فتوتك، ونزق مراهقتك، وانكسارات حبك الساذج لفتيات -أوقعهن الحظ يوماً ببوابة بلوغك الصاخب- فضّلن إدارة ظهورهن، وعدم المجازفة باقتراف علاقة غير مأمونة العواقب.
صحيح أن العودة إلى مدينة سكنتك -قبل أن تمنحك تأشيرة سُكنى فيها- سيبدو أمراً شديد التعسف، وشبيهاً بأحلام الارتداد للرحم، والتي نخدر بها خساراتنا المتراكمة بها عند التعرض لارتدادات عنيفة، لهزائم لم تكن متوقعة، أُسقطت من مآلات حساباتنا، فحضرت، كقضاء وقدر، موجهة لنا صفعة مدوية، تجبرنا على الترنح أو السقوط التام، وعلى رؤوس الأشهاد!
سبايا التأويل
قرابة عِقْد مر، وأنت تحاول تأثيث حياتك بمقاسات مدن أخرى غير تعز، وكان الفشل لصيقاً دائماً لتلك العلاقات الخائبة. ثمة ما يجب الاعتراف به، فالمدن، كما النساء، كما الأوطان أيضاً، يقعن سبايا تأويل كلمات إطراء عابرة قيلت عن غير قصد، ويتهافتن مطرقات، بل قد تصيبهن فتنة جملة مخاتلة، ويقعن فريسة حب غاشم، يمتهنهن بسادية مجنونة… بينما ما يميز علاقتكما (أنت وتعزّك) أعمق من كونها رحماً، احتواك جنيناً، ووهبك امتيازات الخصوصية، ومقامات الذوبان بكل أحوالها وفرادتها في باقي مراحل حياتك.
بالتأكيد إن صراعاً محتدماً، أو سَمّه شجاراً أو قطيعةً بين عاشقين كانا؛ أنت وتَعزًكَ، سيترك ندوباً على صفحة ذاكرتكما، ويرسم بوجهيكما تجاعيدَ ذابلة، وبالمسافة الفاصلة بينكما متاريس يشغلها وشاة، يسدّون الفراغ الذي أحدثه جنونُ غيابك، واستغله الآخرون.
هل ثمة أقسى من عودتك لمدينة أثمر حبها عن تجاعيد تحكي نصف قرن من غرامٍ تليدٍ، وشجن يكسو ملامح وجهك، وعقدٍ من خصام أنيق شوّهَهُ العواذل؟
ستصل تعز عبر طُرقٍ ملتوية، بنصف نهارٍ قاحل ونصف مساءٍ مهدود العافية، ستفرد ذراعيك محاولاً احتضان ما تيسر منها بمرمى يديك، سيغسل عينيك ألقُ إسفلت “الضباب” المبشّر، ونسوةٌ يوشوشن بعض المهاجل، وبعض خفايا البيوت، ويُطلقنَ لأنفسهن عنان الغناء، واختلاس النظر للقادمين إلى مدينة واقعة في ضواحي البصر، لكنها مغروسة في حواشي الصدور.
جريرة الحنين
يا لها من مدينة مسكونة بما لا يُحصى من العشق، والوجد، والحياد، ومعجونة، كذلك، بتفاصيل كل النبوءات والثرثرات، وما يزهق العمرَ؛ غلاءُ المعيشة، فُحْشُ البوالطِ ، نساءُ المدينة الآثمات. حين وطأتْ قدمي “بيرباشا”، تمنيت لو لم أمُتْ كل تلك السنين، تذكرت آخر إجهاشة في عيوني، حين غادرتها، وانسللتُ بعيداً. هربي كان فعلاً غير لائق بعاشقٍ فضّل النأي بنفسه، وتركها للخراب الكبير.
اجتزت المسافة التي تفصل الجهة المقابلة لبوابة نادي الصقر عن جولة بيرباشا، التي يبدو أنها انحنت لعاصفة تمدد قامت بها المباني اللصيقة، فضاعت معالمها بضيق المكان. اجتزت تلك المسافة في ما يشبه الهرولة، بضع دقائق فقط، وصرت محاذياً الجولة، أتفرس في الوجوه الكثيفة التي أحالت المكان إلى بقعة حشر ساخنة، تنُزّ برائحة العرق المالح، وضجيج الأصوات التي تقذفها الأفواه، والسيارات، والدراجات، وتشكل كلها لوحة زعيق متنافر، تذكرني أني وصلت تعز بالفعل، وأن المشهد برمته، لا يعدو عن كونه لحظة احتفائية لتعز، وواحدة من مقامات إعلان ترحيبها بالقادمين إليها.
لم تتغير هذه العادة، لكن أُضيفت إليها لمسات سنواتها التسع الأخيرة، كأن يستفز قدميك أزيز رصاص متقطع أو كثيف، فتطلق ساقيك للريح، وتغدو كرة رأسك بالونة هواء مضغوط، لا أكثر، وقابلة للانفجار، والانفثاء… أو قد يُوقف طبلتي أذنيك عن العمل انفجارٌ مدوٍّ لقنبلةٍ صديقة، سقطت سهواً من جعبةٍ صديقة، أو قذيفة معادية أطلقها الاتجاه المناقض لتلك الوجوه الصديقة، التي أنتجتها سنوات الدفاع عن مدنية مدينة كانت هكذا قبل تدشين الشعار.
لم أكن مستعداً لاستكمال مثل هذه الطقوس، لذا فقد رميت بنفسي فوق دراجة نارية، مُحكماً قبضة يدي على منكبي السائق، وطالباً منه بصيغة آمرة، الانطلاق صوب المركزي “قلب المدينة، ورئتها النابضة بالحياة والتهديد أيضاً”… وفي المركزي، بحثت عن كل أشيائي التي فقدتها ذات رحيل: طفولتي، أصدقاء الطفولة، زملاء التسكع في الأرصفة، النساء اللواتي أدمنت مضايقتهن، وأدمنّ تجاهلي في كل مرة، صديقي الذي لعبت الحرب معه كاليانصيب.