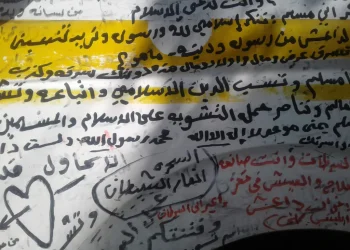اللَّقَاح” في اللغة هم: “الذين لم يُمْلَكُوا، وَلم يَدِينُوا للمُلُوك، ولا يخضعون لدولة، ولا يعطون السلطان طاعةً، ولا يؤدون “إتاوة” لأحد”، قال ثعلب: “الحي اللَّقَاح: مشتق من لقاح الناقة، لأن الناقة إذا لقحت لم تطاوع الفحل”، ومن هنا جاء وجه الاشتقاق، فهذه القبائل ترفض الدولة في ذاتها، وتأبى الخضوع أو الطاعة أو الولاء لسلطة دولة أو قبيلة أخرى، وتتأبى بشدة من دفع “الإتاوة” لأحد من السلاطين أو الملوك، لأن دفع “الإتاوة” رمز للتبعية والطاعة والخضوع المذل الذي يتنافى مع الحرية والاستقلالية وغيرهما من قيم القبيلة البدوية.
“اللَّقَاح” بهذا المعنى: ظاهرة بدوية ضد السلطة، وثقافة قبلية ضد الدولة، وكانت هذه السمة التقليدية بمثابة ثوابت قومية مقدسة لدى القبيلة العربية، كما كانت محل فخر واعتزاز، فعدم خضوع القبيلة لدولة أو ملك أو سلطان. مسألة “كرامة”، وكناية عن قوة وبسالة وعزة القبيلة، قال “خفاف بن ندبة السّلمىّ” مفتخراً:
فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُمْ حَيّاً “لَقَاحاً”… وَجَدّكَ بينَ نَاضِحَةٍ وَحَجْرِ
أشَدَّ على صُرُوفِ الدَّهْرِ آداً… وأكبرَ منهُمُ فِئَةً بِصَبْرِ .
كما قال عبيد بن الأبرص مادحاً :
لَعَمْرُ أبِيكَ والأنباءُ تَنْمِى… لنَعِمَ الحَيُّ فِي الجُلَّى رِياحُ
أبَوْا دينَ الملوكِ فهم “لَقاحٌ”… إِذا هِيجوا إِلَى حربٍ أشاحوا.
عقدة قريش
وهكذا كانت معظم القبائل العربية، وعلى سبيل المثال الشهير، كانت “قريش” من “اللَّقَاح” التي لا تخضع تقريباً لحاكم فرد من داخلها أو خارجها، ولا تتبع دولة، أو هذا ما يقوله الرواة. قال الجاحظ: “لم تزل “مكة” أمناً ولقاحاً، لا تؤدي إتاوة، ولا تدين للملوك”، ورغم أن الشاعر “الحَيْقُطَان “ تهكم بسخرية من افتخار قريش بأنها “لقاح”، لا تدفع “إتاوة” للملوك، في حين أنها تدفع “أريان” “رشوات” لقبائل وعصابات عديدة خوفاً من تعرضهم لقوافلها، مع أنها أسوأ من الإتاوة:
وقلتم: لَقَاحٌ لَا تؤدِّي إِتاوةً… وإعطاءُ أَرْيَان من الضّر أيسرُ!
لكن هذا لا يتنافى مع كونها كانت “لقاحاً”، فلم يكن لمكة ملك أو رئيس فرد، وكانت تحكم نفسها بنفسها من خلال سادة بطونها الذين يجتمعون وقت الضرورة في “دار الندوة” لإدارة الأمور العامة، وإن وجدت فيها مؤسسات قليلة لإدارة بعض الشؤون العامة، وأعراف وتقاليد، وقضاة وقادة وحكماء ووجاهات اجتماعية غير متخصصة تبادر إلى حل أية مشكلة، لمكانتها الاجتماعية التي تجعل حكمها مقبولاً نافذاً على الجميع.
ولعل قصة “عثمان بن الحويرث” ذات مغزى في هذا السياق، حاول هذا القرشي الطموح تحويل مكة إلى دولة، يكون هو ملكها، وفكر أن “بيزنطا” قادرة على تحقيق مشروعه، فاعتنق “النصرانية”، ورحل إلى قيصر، وأغراه بضرائب مكة، فوافق على خطته وأعطاه تكليفاً مكتوباً ليعرضه على قومه، وفيه عروض بتسهيلات وامتيازات تجارية واسعة، حاول “عثمان” بذكاء إغراء قريش بها، وإقناعهم بقبوله ملكاً.
وبالفعل، قبِل معظم “الملأ”، في مكة برئاسة “عثمان”، وكادت قريش أن “تعقد التاج على رأسه”، لولا قيام بعضهم بتذكير قريش بعقدتها المزمنة تجاه الدولة والملك، منهم ابن عمه “الأسود بن أسد بن عبد العزى”. صاح بقريش: “ملك بتهامة؟! ألا إن مكة حي لقاح لا تدين لملك”، “فانحاشوا انحياش حمر الوحش”، ثم قالوا: “صدقت، واللات والعزى ما كان بتهامة ملك قط”، وهكذا فشلت محاولة “عثمان بن الحويرث” بالتملك على مكة.
من المؤكد أن طموحين آخرين فكروا، أو حاولوا فعل المثل في “يثرب” و”ثقيف”، وبقية القبائل “المستقرة” في وسط وغرب الجزيرة العربية، ولا بد أنهم اصطدموا في كل مرة بهذا الجدار الثقافي الاجتماعي السياسي الصلد “ثقافة اللقاح”، والتي هي بمثابة شكل مبكّر من الـ”أناركية= اللاسلطوية” بفلسفتها السياسية والأيديولوجية الحديثة المعادية للدولة، ومختلف أشكال السلطة.
وكما يُفترض دائماً، لهذه الظاهرة الـ”أناركية البدوية”، أرضية جيوسياسية وشروط بيئية واجتماعية واقتصادية… خاصة، تشكلت فيها، وانبثقت عنها.
ومن المؤكد أن هذه الثقافة البدوية، انعكاس للحياة البدوية حياة “الأعراب” “البدو الرحل”، ونمط حياتهم القائم على التماهي مع الطبيعة، في ظلال حميمة من التناغم وا لعفوية والبساطة والاستقلال والانطلاق الحر، والنفور من القيود والالتزامات والتبعية لأية سلطة فردية خارج أو داخل القبيلة.
هكذا تعيش “النوارس” أيضاً، مع الأخذ بالاعتبار الفرق بين الغريزة والثقافة، وانسياقاً مع هذا التشبيه، نمط الحياة الحر القائم على الهجرة لمختلف أنواع الطيور المهاجرة، يماثل نمط الحياة الثقافي البدائي بالنسبة للبدو الرحل من العرب، فهو بدوره قائم منذ أقدم العصور، على العبور والسفر والترحال والهجرة… على ظهور الجِمال، الرفيق الأكثر أهمية وحميمية وضرورة للإنسان العربي طوال التاريخ.
أخلاق التوحش
في الحالتين، نحن أمام حياة بدائية قريبة من الفطرة، بقدر بعدها عن “الحضارة” التي هي في الأساس موقف إيجابي للإنسان من الطبيعة، ومحاولته تغييرها لصالحه، في حين أن “البداوة” موقف سلبي انهزامي أمام الطبيعة، واستسلام لها، ومجاراتها، وبالشكل الذي أجبرت فيه البيئة العربية المتصحرة التي يغلب عليها الجفاف والشحة، البدو على التنقل السرمدي وراء الماء والمرعى، والصراع الدائم للسلب والنهب والاستيلاء على ما بأيدي الآخرين.
كما أن “الدولة” باعتبارها أحد أعظم إنجاز حضاري مدني في التاريخ، تشترط مبدئياً استقرار المجتمع، وتواشج علاقة الإنسان بالمكان، والإنتاج المنتظم، وفائض الإنتاج… وهذه الشروط لم تتوفر في تلك البيئة الصحراوية الجافة الشحيحة التي تحول دون أي تراكمات، ليتحول العجز البدوي عن بناء دولة، إلى رفض لها، ومن ثمّ تحول هذا النمط الإجباري من العيش، إلى مبادئ وثقافة حياة، تتميز في ما يتعلق بموقفها من الطبيعة والحياة والعالم، بسمتين متداخلتين متكاملتين هما:
– الحرية:
و”الحرية” هنا -بخلاف معانيها وتجلياتها الحديثة- تتجسد في علاقة البدوي بالمكان والطبيعة والمدنية والسلطة… وهي علاقة سلبية، وانتهازية غالباً، وفق نمط حياة مقترن عادةً بالتشرذم والهجرة وراء الماء والمرعى، وبشكل يجعل العلاقة بالأرض، وبالتالي بالمجتمعات الثابتة، والسلطات المرتبطة بالأرض، مؤقتة عابرة، فالبدوي بلا وطن، وبلا دولة. إنه يعيش حرية فطرية مطلقة تقريباً.
وهذا ما لاحظه قديماً، بإعجاب، وربما بتعجب، بعضٌ من كبار مؤرخي اليونان واللاتين، كالمؤرخ “هيرودوتس”، الذي أشاد، في “القرن الخامس ق.م”، “بحب العرب للحرية، وحفاظهم عليها”، ومثله وصفهم المؤرخ اليوناني “ديودورس الصقلي”، في “القرن الأول ق.م”، بأنهم: “يعشقون الحرية”، مضيفاً: “إنهم لا يزرعون حبّاً، ولا يغرسون شجراً، ولا يشربون خمراً، ولا يبنون بيوتاً…”.
– الأنفة:
ومنها الاستنكاف من التبعية للملوك والدول والحكام… وهو موقف مبدئي سلبي من مختلف أنواع السلطات. وهذا بالتحديد أهم ما يميز “البداوة” على الصعيد السياسي الاجتماعي: “استقلال” القبيلة بذاتها، ونفورها من “السلطات” الخارجة عنها، ورفض الخضوع للدول والملوك والحكم الفردي، والجموح أمام أية محاولة لترويضها، جموحاً يشبه جموح “الناقة” بعد “لقاحها”، على أي فحل يحاول امتطاءها، ومن هذه الحالة المألوفة في حياة القبيلة البدوية، اشتق العرب بشكل تشبيهي المصطلح الآنف “اللَّقَاح”، ليعبر عن جموحهم ورفضهم الخضوع للسلطات والملوك.
أطلق “ابن خلدون” على هذه السمة البدوية مصطلح “خلق التوحش”، مؤكداً أنها أكبر عقبة حالت وتحول دون قيام دولة دنيوية لهؤلاء البدو، وحسب قوله: “العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة”: “والسّبب في ذلك أنّهم لخلق التّوحّش الّذي فيهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض، للغلظة والأنفة وبعد الهمّة والمنافسة في الرّئاسة، فقلّما تجتمع أهواؤهم، فإذا كان الدّين بالنّبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم، وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم، فسهل انقيادهم واجتماعهم”. مضيفاً: “وهم مع ذلك أسرع النّاس قبولاً للحقّ والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات، وبراءتها من ذميم الأخلاق، إلّا ما كان من خلق التّوحّش”.
ربما من الجدير تأكيد أن كل هذه الخلفيات والشواهد… تتحدث حصراً عن “الأعراب” “البدو الرحل”، وهي بهذا، وإن فسرت لياقة “ثقافة اللقاح” بهم، لا تفسر الحضور المهيمن لهذه الثقافة لدى القبائل العربية المستقرة، كقريش ويثرب والطائف… والتي هي بحكم استقرار مجتمعاتها واقتصاداتها التجارية أو الزراعية الثابتة، وفائض إنتاجها وتراكماتها… مؤهلة لتكون بمثابة “دول -مدن” كما في “اليونان القديم”!
والواقع أن هذه المجتمعات المستقرة، رغم مؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية للتمدن والتحضر… عجزت، أو بتعبير أدق رفضت، في ذاتها، التحول إلى دولة، ربما لكونها في الأخير امتداداً جينياً وثقافياً لمجتمعات البدو الرحل، فـ”الأعراب أصل العرب”، كما قال “عمر بن الخطاب”، وبالتالي “الطبع يغلب التطبع”، حسب المثل العربي، أو لأن “البداوة تغلب المدنية”، حسب فلسفة “ابن خلدون”!
وأياً كان الأمر، نحن هنا أمام ظاهرة عامة حضرت على امتداد تاريخ الجغرافيا العربية القديمة، مع أهمية الأخذ بالاعتبار التعامل مع تعميمات الأخبار التراثية ذات العلاقة، بحذر شديد. فهذه القبائل كانت في الجاهلية خاضعة لدول في اليمن أو الحيرة أو الفرس أو الحبشة، وكان أهلها يدفعون “إتاوات” لها، حسب نقوش يمنية ولخمية ووثائق كلاسيكية يونانية ورومانية، وما نفهمه من هذه التعميمات هو أن هذه القبائل لم تكن تُحكم مركزياً من قبل هذه الدول، وأنها كانت مستقلة إلى حد كبير، والأهم أنها لم تسمح لنفسها بنظام دولة داخلها، أو حتى في تكتلاتها القبلية، كما كانت دائمة التمرد على الدول المسيطرة.
ورغم أن هذه القبائل كانت محاطة بدول قوية عريقة، كالفرس والروم واليمن، وبعضها امتداد قومي لها، كالمناذرة والغساسنة وكندة، وكانت لهم صلات مكثفة مع هذه الدول، ويخضعون كثيراً لها، ويقاتلون أحياناً في صفوفها… إلا أنهم لم يتأثروا مطلقاً بالأنظمة السياسية والاجتماعية لها، لأسباب تتعلق بالجذور العميقة والأسس المكينة لنمط الحياة البدوية، وهذا ما جعل ظهور دولة عربية في قبائل وسط وشمال وغرب الجزيرة العربية قبل الإسلام، أمراً في منتهى الصعوبة. فكانت أكبر سلطة تبلورت للعرب في ظل ذلك النمط البدوي للعيش، هي القبيلة، فـ”أسمى ما وصل إليه البدوي في استخلاص المصلحة العامة لا يتجاوز القبيلة، أما النظام واحترام الشرائع وطاعتها وخضوعه للسلطة… فليست من مزاياه”.
والحاصل أن هذه “الحرية”، كما يسميها اليونان، أو “خلق التوحش”، بعبارة ابن خلدون، أو صفة “اللَّقَاح” بعبارة العرب أنفسهم حالت دون تطوير العرب لطريقة ناعمة في بناء الدولة وتداول السلطة، فظلت قبائل الحجاز ونجد وعموم قبائل وسط وشمال الجزيرة، طوال تاريخها القديم، مجرد قبائل بدوية تتحالف لفترة، وتتناحر لفترات، ولم تعرف ظاهرة “الدولة”، بمعناها الكلاسيكي، إلا مع الإسلام، وحتى بعد الإسلام، ظلت هذه الثقافة حاضرة ومؤثرة في علاقة هذه القبائل بالدولة، بل إنها تسربت إلى مجتمعات وأقاليم ذات تاريخ سياسي عريق في الاستقرار والمدنية والحضارة وبناء الدولة، وماتزال حاضرة بأعراضها السلبية، بشكل محدود، في أقاليم قبلية محدودة من العالم العربي.