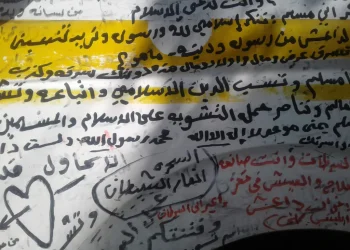“حكاية قرية رحل عنها الظل حين سقطت نخلاتها العاليات وانكشف رعب الشمس”.
بهذه العبارة الشعرية، السوريالية، يختتم رضوان الكاشف تحفته “عرق البلح”، وقد مر على العرض الأول لهذا الفيلم 22 عامًا، أغسطس 1998، لكنه من الأفلام التي لا تبلى؛ ليس لموضوعه الذي مازال حاضرًا، ولكن الأهم لقيمته الفنية، وكادراته البصرية وموسيقاه التصويرية وأداء أبطاله المدهش.
يعودون غرباء
الهجرة، والغربة، موضوع أساسي في السينما المصرية، العديد من المخرجين عالجوها بوصفها مشكلة، إما كقصة محورية أو ثانوية. يصور فيلم “أرض الأحلام” (1993)، لداود عبدالسيد، قصة نرجس (فاتن حمامة) التي يمنعها الحنين لمصر من الهجرة إلى أمريكا حتى قبل سفرها، وبرغم العناء الذي تقاسيه هنا، في القاهرة، والمغريات التي ستحصل عليها هي وابناها هناك، إلا أنها ترفض السفر؛ فأرض الأحلام الحقيقية ليست أمريكا، وإنما هي الأرض التي ولدت وترعرعت فيها. هذا ما تحاول فكرة الفيلم إيصاله للمشاهد من خلال عنوان الفيلم ومضمونه.
والمدينة في رؤية يسري نصر الله هي بالنتيجة واحدة، سواء كانت القاهرة أو باريس. والفارق يصب لصالح القاهرة؛ فباريس قد تمنحك المال، لكنها ستسرق منك راحة البال، وستسلبك ذاكرتك لتعود إلى بلدك بلا تاريخ. هذا ما تخلص إليه قصة فيلم “المدينة” (2000). وتدور أحداثها حول علي (باسم سمرة) الممثل الطموح، الذي يعيش في منطقة روض الفرج، مع أبيه وأمه، ويعمل محاسبًا في إحدى الجمعيات الحكومية. لكن، مع مرور الوقت، يدرك أنه لا يستطيع أن يحقق ما يطمح إليه في التمثيل أو في الحياة، بخاصة مع سيطرة والده المتنامية، فيقرر السفر إلى فرنسا، ويكسب قوت يومه هناك من مباريات الملاكمة غير المرخصة. يتفاقم صراعه مع القائمين على تلك المباريات، ونتيجة حادث يفقد ذاكرته، ويعاد إلى القاهرة حيث يبدأ حياته من جديد. لكن فقدانه ذاكرته لن ينسيه حبه للتمثيل وحبه الأول نادية “بسمة”.
الرحيل بلغة سوريالية
ولأحمد عبدالله في “ليل خارجي”، قصة ثانوية، بمسار مستقل عن خط القصة الرئيسية، عن مسافر شاب يهجر حبيبته بحثًا عن فرصة أفضل، فيغرق في البحر. والأعمال السينمائية التي تناولت ثيمة الرحيل، أو الغربة والاغتراب، كثيرة، لكن ولا واحدة، من بين الأفلام التي شاهدتها، لمستها بالعمق والجمال، كما فعل رضوان الكاشف في “عرق البلح”. لا يقدم لنا الكاشف قصة تقليدية عن أناس هجروا بلدانهم ونساءهم بحثًا عن المال فحسب، ولكنه يركز على الأثر النفسي الذي تخلفه الغربة والانتظار، وعلى الفقد نتيجة هذا الرحيل في نفوس النساء تحديدًا.
أكد الكاشف على الأثر الجنسي؛ الرجال يموتون في الغربة أو يعودون غرباء، والزوجات يمتن في انتظارهم رغبةً. فإن عاد الرجال لا تعود حياتهم ولا حياة نسائهم كما كانت. برحيل الرجال عن القرية تتأجج رغبة النساء، ومع مرور السنوات يفقدن هذه الرغبة. يتضح هذا بمشهد لسليمة (عبلة كامل) وهي تجر أحمد إلى سريرها، لكن بعد عودة زوجها بسنوات يطلبها فتصده، بما يلمح إلى موت رغبتها. وسيتجسد هذا الكبت في صور عديدة، منها لعبة “عريس وعروسة” بين طفل وطفلة.
الجد نفسه (حمدي أحمد) مهاجر سابق، لم يهاجر من بلدته الأولى من أجل المال، ولكن هربًا من طمع الناس، فبنى في الصحراء وزوجته وطنهما البديل، ومنهما تناسل الأبناء، الذين سيكررون قصة الرحيل لسبب مختلف. وكأن قدر الرجال أن يرحلوا، وقدر النساء أن ينتظرن. المرأة هي الوطن، هي النخلة، والرجل هو البذرة التي تلقحها، فإن رحلوا تبور الأرض. هي قصة عن جد صارع قسوة الشمس والصحراء بزراعة النخل، بنى مع زوجته زين (فائزة عمسيب)، وطنًا من الصفر، ففرَّط فيه الأبناء، وسقطت نخلاته العاليات، وانكشف رعب الشمس.
لم يكن لمثل هذه القصة التقليدية أن تُقدم إلا ببساطة سوريالية رادَفَ فيها الكاشف بين الرحيل والموت، فجعل الرحيل شكلًا من أشكال الموت. يمرض الجد الأخرس بمرض عضال، وحين يقوم من مرضه، ويمتطي حصانه، نعتقد أنه قد برأ من مرضه، لكنها لوحة سوريالية للموت. تودعه زوجته إلى رحلته الأخيرة قائلةً: “مع السلامة يا سِيدي، مع السلامة يا خويا، مع السلامة يا بويا، مع السلامة يا وِلد عمي، مع السلامة يا حبيبي…”. وتقول لحفيدها أحمد: “راكب الفرس ورايح بعيد، يومين والفرس حيعاود”. يسألها حفيدها: “وجَدِّي؟”، فتجيبه: “رحلته طويلة”. وبطريقة الموت نفسها يمضي الحفيد أحمد ممتطيًا الحصان، بعد أن قتله رجال القرية، وبكلمات الوداع نفسها تودع سلمى حبيبها أحمد: “مع السلامة يا خويا، مع السلامة يا جوزي، مع السلامة يا حبيبي”.
تمتزج هذه السوريالية مع كلمات أغنية “بيبه”. كان رضوان الكاشف قد طلب من الشاعر عبدالرحمن الأبنودي أن يكتب له أغنية “ملهاش معنى، وفيها كل المعاني”. احتار الأبنودي في كتابة أغنية بهذه الصفة! فلجأ إلى كنزه، أُمه فاطمة قنديل. تذكر أغنية كانت تغنيها له وهو صغير، تكرر فيها لازمة “بيبه”، وبيبه تعني البلح الصغير. وقد أدت الأغنية، بمنتهى الجمال، وبنبرات صوتية مختلفة؛ ليعبر كل أداء صوتي عن الشخصية في الفيلم، كل من شيريهان وعبلة كامل ومنال عفيفي، وغنتها مديحة السيد، في تتر النهاية، بدون موسيقى، وببحة حزن وألم.
“بيبه، عمي حماده، بيبه، جابلي طبق، بيبه، مليان نبق، بيبه، قالي كلي، بيبه، قلتله ماكولشي، بيبه، وديه لُامك، بيبه، أمي بعيد، بيبه، آخر الصعيد، بيبه، والصعيد مات، بيبه، خلف بنات، بيبه، خلف بنية، بيبه، قد القطية، بيبه، خدها عليا، بيبه، خدها بدبايح، بيبه، والسمن سايح، بيبه، سايح لفوق، بيبه، وعمل له طوق، بيبه…”.
رمزية النار والنخلة
كلمات أغنية بيبه، والرقصة المصاحبة لها، محملة بالمكبوت الذي يعتمل في صدور نساء النجع. تُعبِّر الكلمات عن غياب الرجال، والأثر الجنسي الذي يخلفه ذلك الغياب. النار التي تعتمل في نفوس النساء وأجسادهن، سنجده متجسدًا في طرحة/وشاح سلمى (شريهان)، وفي أدائها الراقص، وهي وسط حلقة النساء. الطرحة مبطنة بلون أصفر ناري. تخلعها سلمى وتطوف بها وسط حلقة النساء، كأنها تُحذِّر مما يمكن لهذه النار أن تفعله بهن إن خرجت إلى العلن. يأتي دور شفا (منال عفيفي) في الغناء والرقص، فتعبر عن رغبتها الجسدية بخلعها طرحتها، رمز عفتها، وبالرقص وهي حاسرة الرأس ملتصقة بالطبال. إشارة جنسية تعيها سلمى، فتهمس في أذن الجدة لتتدخل وتفض الاشتباك الجسدي الراقص. لاحقًا ستشارك سلمى في إجهاض الجنين الذي تحمله شفا من الطبال، لكن أمرًا كهذا لن يخفى على النساء، ولن يمر دون عقاب، في بيئة تُجرِّم الحب المحرم، وتُعبِّر عن إدانة النساء للنساء.
حلقة النساء ستلتم ثانية، من أجل هدف مختلف، حول نار صغيرة يضرمنها بمزيد من الحطب، وبلغة العيون يحكمن على شفا بالإعدام. تَقبل شفا الحكم بصمت، فتندفع نحو النار وتحترق بها، في الوقت الذي تردد سلمى، نادبةً بنبرة هي مزيج بين القوة والضعف، لتعبر عن شخصية المرأة: “وأووه يا شمس نخلتنا العالية عالية، في السما العالية عالية، وزرعناك يا شمس ظلي، وإن غاب راجلنا ما يغيب ظلي”، في إشارة إلى قوة المرأة واستمرار ظلها، رغم غياب الرجال، وغياب ظلهم الموصوف في المثل “ظل راجل ولا ظل حيطة”.
النخلة هي المرأة، والرجل هو من يتمكن من اعتلائها. بعد اعتلاء أحمد للنخلتين، الحقيقية متمثلة في الشجرة، والرمزية متمثلة في سلمى، يحكم عليه رجال النجع بالإعدام. يجعلونه يتسلق النخلة ثم يقطعونها. العقاب الذي ناله أحمد سببه في الظاهر ممارسته الجنس مع سلمى، لكن ثمة دلالة ثانية هي غِيرة الرجال من مكانة أحمد العالية في نظر النساء. تلك المكانة، التي بلغها في غيابهم، أسقطها رجال النجع بالطريقة نفسها التي نالها بها.
من الواضح أن الكاشف تأثر بفيلم “الطوق والإسورة” (1986)، لخيري بشارة، المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه ليحيى الطاهر عبدالله، ويعالج فيها مواضيع عدة: أثر الغربة، والجهل والشعوذة والحب المحرم وجرائم الشرف، والثقافة الذكورية، وهي الموضوعات نفسها في فيلم “عرق البلح”، والأسرة الرئيسية في الفيلمين تتكون من أب يعاني من مرض عضال يموت وتبقى المرأتان؛ الأم وابنتها في الطوق والإسورة، والجدة وحفيدتها في عرق البلح، حد أن شيريهان قامت بدور الأم وابنتها (فهيمة وفرحانة)، وهو ما ستفعله بعد مرور 13 عامًا في “عرق البلح”. لكن فيلم الكاشف لم يتحول إلى صدى لصوت، بل هو من الأمثلة القليلة التي تؤكد على أصالة التناص الذي قد يتفوق النص اللاحق على السابق. تدور أحداث فيلم “الطوق والإسورة” في العام 1933، في قرية الكرنك بالأقصر، حيث تعيش حزينة (فردوس عبدالحميد) مع زوجها المشلول والمصاب بالسل بخيت البشاري (عزت العلايلي)، وابنتهما فهيمة (شيريهان). لسنوات تترقب حزينة عودة ابنها مصطفى المغترب في السودان بحثًا عن لقمة العيش. بعد وفاة البشاري يتزوج الحداد الجبالي من فهيمة،
تتأخر في الإنجاب، فتلجأ أمها إلى المعبد ليباركها الشيخ هارون، ونكتشف أن زوجها مصاب بالعجز، ويأتي الحل على يد حارس المعبد نفسه، فتنجب فهيمة طفلتها فرحانة التي لا يعترف بها الحداد، وتمرض فهيمة وتموت نتيجة العلاج البدائي، وتمر السنوات، ويعود خالها مصطفى بعد سفره الطويل، ويحاول تغيير
مفاهيم أهل القرية دون جدوى،وتحمل فرحانة بدون زواج، وتموت قتيلة على يد ابن عمتها.
قصة لا تنتهي
يريد الكاشف أن يقول لنا إن هذه القصة قديمة، ومتكررة، ولهذا جعل السرد دائريًا. يبدأ الفيلم بالقصة من آخرها، بمشهد لشاب غريب (عبدالله محمود) وهو يحمل حقيبة سفر، سنعرف لاحقًا أنه عائد إلى النجع الذي رحل عنه أبوه، وأنه أحد أحفاد الجدة زين. يجوب الشاب الغريب ممرات القرية، ولا يجد سوى أطلال بيوت فارغة، وبعد بحث ونداءات يلتقي بجميلة (شريهان) -سنعرف لاحقًا أنها ابنة سلمى من علاقة غير شرعية بأحمد الذي مات غدرًا. تفر منه جميلة فيلاحقها ليجدها عند الجدة زين. هنا تحكي له الجدة، بتقنية “فلاشباك”، ما حل بالقرية وأهلها. وبإعادة ترتيب زمن القصة تكون الافتتاحية نهاية سعيدة يكشف المسكوت، بالتلميح، عن حياة جديدة سيبنيها الحفيد مع جميلة.
ويموتون غرباء
لغة هذا المشهد الافتتاحي هي العربية الفصحى، واختيار الكاشف للفصحى لغة لهذا المشهد، فيه إشارة إلى أن ما سيحكيه لاحقًا، بالعامية المصرية، هي قصة أو مشكلة عربية وليست مصرية فحسب. سنجد تناولًا لموضوع الهجرة والاغتراب في نوفيلا يمنية شهيرة بعنوان “يموتون غرباء” (1971)، للروائي اليمني محمد عبدالولي، عن عبده سعيد الذي يهاجر إلى الحبشة/إثيوبيا للعمل، تاركًا زوجته وطفله في إحدى قرى اليمن.
يفتح عبده سعيد دكانًا في إثيوبيا، فتدر عليه التجارة مالًا وفيرًا يرسله إلى قريته. يصف السارد أول آثار الهجرة على نفسية عبده سعيد، قائلًا:
“لقد شعر عبده لأول مرة بالمسافة الزمنية التي عزلته عن القرية، لقد أصبح جدًا، وأصبح مالكًا لأحسن منزل في القرية، وأكثر من هذا وذاك، لقد أصبح يمتلك الكثير من أرض القرية… أما ابنه فتركه حين كان في الثامنة من عمره، واليوم هو صاحب دكان في المدينة. أما زوجته فكان يتصورها كما تركها في الثانية والعشرين من عمرها، صغيرة، هادئة، وفي وجهها أحلام بريئة، ونظرات بسيطة. كان يبتسم أحيانًا وهو يجاهد ليرسم صورتها في خياله، وكثيرًا ما يفشل. كان وجهها قد انمحى من رأسه تمامًا، وعندما كان ينجح في رسمها كانت صورتها تختلط بصور عشرات النساء اللواتي مر بهن في أديس أبابا”.
طيلة سنوات ظل عبده سعيد يحلم بالعودة، يحلم “أن يصلي صباح كل يوم فوق سقف منزله الجديد حتى يراه أهل القرية، أن يذهب إلى البستان يقطف من فاكهته، وأن يطارد الأطفال، ويمنع النساء بمرح من أن يتخذن ظلال بستانه مكانًا لراحتهن عند عودتهن من جلب الحطب، أن يثبت سلطته”.
يبنون في غياب عبده سعيد بيتًا، ويشترون الأراضي، ويشب ابنه دون أن يراه، ثم يموت عبده سعيد أخيرًا في دكانه وحيدًا وهو يحلم بالعودة إلى قريته وإكمال بقية حياته مع زوجته. يصف السارد هذه اللحظات بقوله عن عبده سعيد:
“مات ولم يترك شيئًا طيبًا في حياته سوى الآلام، امرأة مهجورة منذ أعوام بعيدة، وابنًا لم يعرفه، وأرضًا لم يقدم لها أي قطرة من دمه. لقد مات غريبًا كما يموت مئات اليمنيين في كل أنحاء الأرض، يعيشون ويموتون غرباء دون أن يعرفوا أرضًا صلبة يقفون عليها… تركوا أرضهم، بلادهم، وأهلهم وراء لقمة العيش، فيموتون جريًا وراء اللقمة قبل كل شيء”.
ويدين الروائي على لسان السارد هذا النوع من الهجرة، فيصفها بأنها خيانة: “شعب يهاجر من أرضه- شعب خائن لتلك الأرض- الظلم يجعل الخيانة شيئًا بسيطًا، ولكنه لا يبرر الفرار”.
فنارات السينما المصرية
فيلم عرق البلح، نخلة باسقة في تاريخ السينما المصرية. والسر في كمال هذا الفيلم، هو في تناغم واكتمال جميع عناصره، من قصة وسيناريو وحوار وأداء وموسيقى تصويرية. لكن المتابع للسينما المصرية، ولسينما المؤلف تحديدًا، يمكنه أن يرسم مؤشرًا يصعد ثم يهبط، وفي أعلى نقطة، في المثلث، سيجد في مسيرة كل مخرج عملًا أو اثنين. مثل هذا المؤشر، المثلث الشكل، بفنارته الوحيدة، لن تجده في أغلب سينمات المؤلف في العالم. وهنا أسأل: لماذا يهبط هذا المؤشر؟! لماذا يترجل المخرج المؤلف عن صهوة مجده؟! لماذا لا يكرر نجاحه ويصنع تحفًا أخرى؟! أهو فقر في الخيال؟! هل نقطته المضيئة كانت مكافأة وحيدة يهبها الحظ مرة واحدة لكل مجتهد؟!
الإنتاج أحد سببين. هذا السبب يمكن التغلب عليه بالبحث عن منتج خارجي، كما يفعل الكثير من المخرجين حول العالم. لكن السبب الأهم هو أن عين المخرج والمنتج على شباك التذاكر أكثر مما هي على صناعة سينما حقيقية. ولهذا ستجد تباينًا واضحًا، وفارقًا كبيرًا، بين فيلم عرق البلح وفيلم رضوان الكاشف الذي يليه، “الساحر” (2001)، أو الذي سبقه “ليه يا بنفسج”.
الأهم من كل ما سبق، أن تلك الفنارات القليلة لا يُهتدى بها من قبل الجيل التالي من المخرجين، وبهذا لا تصبح السينما فعل تراكم، فلا تتقدم. وإلا كيف يمر فيلم مثل “عرق البلح” ولا يصبح مصباحًا يهتدي به كل من يصنع فيلمًا يعالج قضيةً فيلمسها بالأسلوب السوريالي الذي لمس به رضوان الكاشف فيلمه، فيتخلص بهذا الأسلوب من المباشرة التي تكون مدعاة للرتابة وإعراض المُشاهد؟!
أنجز شادي عبدالسلام تحفته “المومياء” في 1970، وبالنظر إلى ما أنجزه بعد هذا التاريخ وحتى وفاته (1986)، فلن تجد ما يقترب من الموياء. تكمن عبقرية الإبداع الفني في البساطة، وهذا ما يميز فيلم عرق البلح. تلك البساطة كان محمد خان قد وجدها في فيلم “خرج ولم يعد” (1985)، عن قصة الكاتب البريطاني ه. ب. بيتس. ثم عاد إليها في فيلم “في شقة مصر الجديدة” (2007)، بالفكرة نفسها تقريبًا: أن تذهب للبحث عن شيء وتجد شيئًا آخر لم يكن في الحسبان.
في “خرج ولم يعد” يسافر عطية (يحيى الفخراني) لبلدته الريفية لبيع ميراثه من أبيه: ثلاثة فدادين. وفي هدوء الريف وسكينته يجد نفسه، ويجد الأهم: الحب الذي لم يعشه مع خطيبته في المدينة، خلال سبع سنوات خطوبة. وجده في الفتاة الريفية خيرية (ليلى علوي) خلال أيام معدودات. الفكرة نفسها نجدها في فيلم “في شقة مصر الجديدة”، لكن برحلة عكسية من الريف إلى المدينة.
تنتهز نجوى (غادة عادل) فرصة مجيئها إلى القاهرة، في رحلة مع زميلاتها، لتبحث عن “تهاني” مُدرستها التي علمتها الموسيقى والحب. تتحول رحلة نجوى إلى سلسلة من المغامرات، وتصبح شقة مصر الجديدة مكانًا يلتقي فيه اثنان من عالمين مختلفين. تذهب للبحث عن مدرستها فتجد الحب. وبعد سبع سنوات يعود محمد خان بفتاة المصنع، كأنه لم يجرب البساطة ولم يصعد إلى قمتها من قبل!
لماذا تأفل النجوم؟!
من اللافت في هذه النماذج من الأفلام أن أبطالها يترجلون عن قممهم، ربما لأنهم لا يجدون قممًا أخرى يتسلقونها. هكذا فعل محمد نجاتي بعد دوره المدهش في فيلم “عرق البلح”، ومثله فعلت منال عفيفي، التي حُصرت أدوارها القليلة التالية في خانة الإغراء. والأمر لا يتعلق بتقديم التنازلات، ولكن بقلة الخيارات، وربما بلقمة العيش، وهي الأسباب نفسها التي تدفع إلى الغربة في الخارج أو الاغتراب في الداخل!